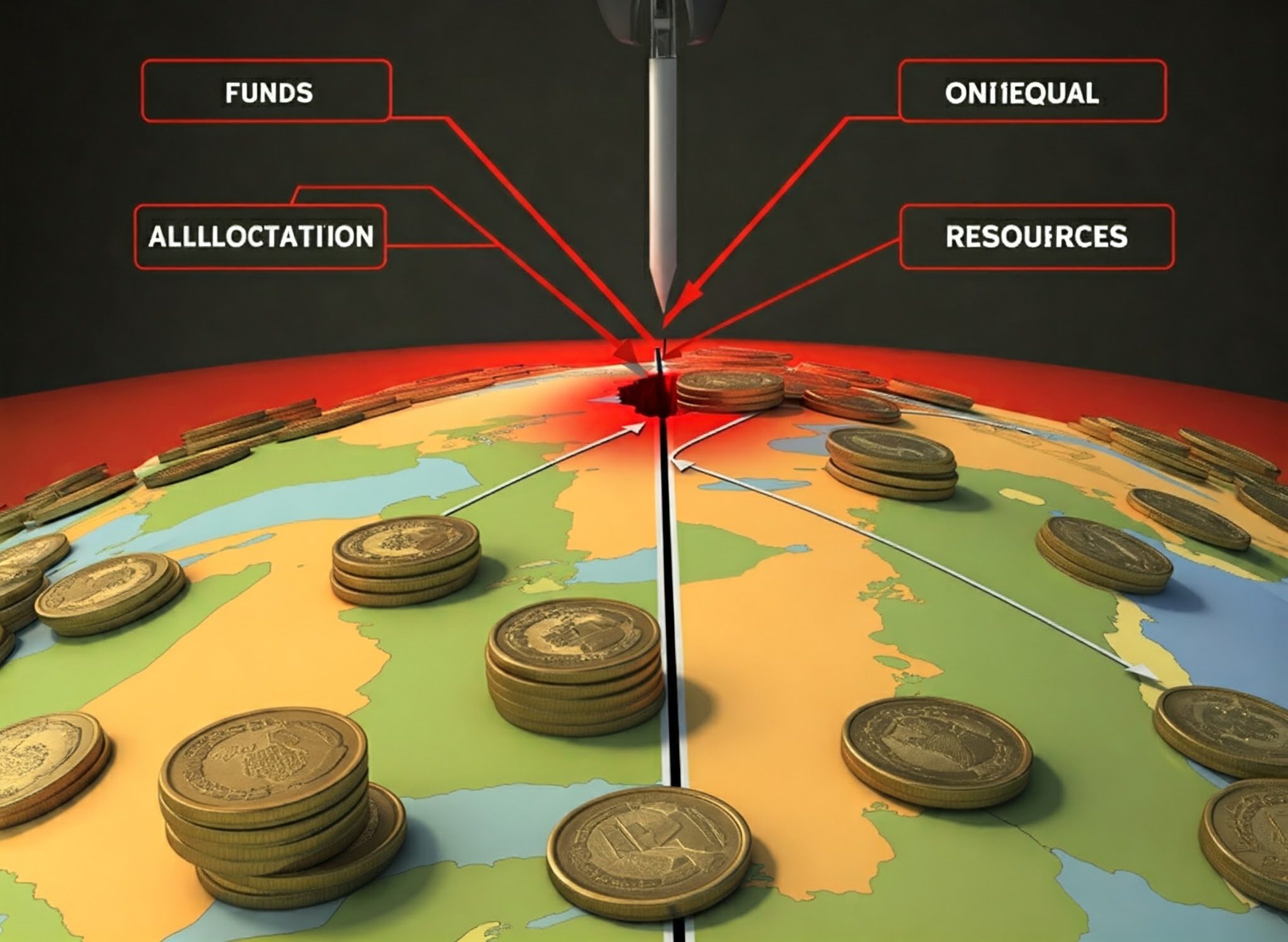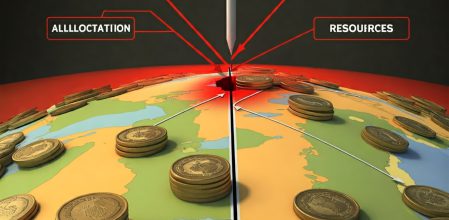By: FI
Introduction
Years ago, I worked on a project for an international organization that received substantial funding. I was struck by how little of that funding actually reached the target group. It seemed that the primary focus was on reallocating funds internally to address organizational cuts, only later modifying the program for the intended beneficiaries.
This blog examines the allocation of funds in development programs, highlighting the gap between what international organizations absorb and what reaches target countries or communities.
Fund Breakdown Example
Let us imagine a development project with a total budget of 10 million EURO, funded by international donors. Here is a breakdown that reflects typical spending patterns:
- Administrative and Operational Costs (45% – 4.5 million EURO): This covers salaries for international staff, office operations (rent, technology, supplies), travel, and program management overhead.
- Monitoring, Evaluation, and Reporting (20% – 2 million EURO): This portion funds data collection, outcome reporting, donor accountability audits, and capacity-building workshops for international staff.
- Local Implementation and Capacity Building (10% – 1 million EURO): Supports the training of local staff, workshops, and materials to strengthen community involvement and expertise.
- Local Program Implementation (15% – 1.5 million EURO): Direct project costs like infrastructure, local staff salaries, services, and procurement of local resources are funded here.
- Community Outreach and Awareness (5% – 500 thousand EURO): Public awareness campaigns, educational initiatives, and media outreach aimed at engaging local communities are covered by this allocation.
- Direct Financial Assistance (5% – 500 thousand EURO): Provides grants or financial aid to beneficiaries such as businesses, schools, and healthcare centers.
This budget breakdown reflects common spending patterns in international development projects funded by donors like USAID, UNDP, or the World Bank.
Accountability and Efficiency
A significant concern with this type of budget allocation is how much of the funding is absorbed by international organizations rather than benefiting local communities directly. Nearly 80% of development aid is consumed by administrative and operational costs, leaving approximately 20% for direct local implementation and aid. This has been widely criticized for its inefficiency. Scholars such as William Easterly argue that a substantial portion of the funds intended for development are redirected to sustain bureaucracies rather than reaching the intended beneficiaries (Easterly, 2007).
For example, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Co-operation Report (2021) revealed that in some humanitarian contexts, up to 70% of funds are spent on administrative costs, limiting direct aid to the affected populations. This critique is echoed in Melber et al.’s (2024) work, which emphasizes the need for more equitable resource distribution that aligns with local needs and contexts.
While donors defend administrative costs as essential for accountability and oversight, critics assert that these expenses often divert crucial resources from local communities. The Global Humanitarian Assistance Report (2022) shows that significant funding is allocated for monitoring and evaluation, rather than frontline aid, which undermines the overall impact of development projects. The concept of the “network society,” as articulated by Manuel Castells, explains how international organizations leverage global finance and information networks to justify their high overhead costs (Castells, (1996).
The Power Dynamics of Aid
This imbalance in funding distribution reflects deeper global power dynamics. International organizations often function as gatekeepers, controlling resources while reinforcing dependency and unequal power relations between donors and recipients. This critique is supported by Roth et al. (2024), who note that local organizations are frequently sidelined in favor of international entities, which affects the relevance of projects and hinders local capacity development.
The way international organizations frame development narratives often elevates their role as “experts,” while minimizing the voices of local communities. Communication theories, such as Stuart Hall’s Encoding/Decoding model, help us understand how these organizations shape the development discourse, portraying themselves as indispensable while limiting local participation (Hall, 1980).
Local vs. International Expertise
A key issue in the aid debate is the balance between international expertise and local knowledge. Should more funding be directed to local organizations to empower them, reducing dependency on expensive international intermediaries? Critics like Easterly argue that the heavy reliance on international consultants can overlook the potential for local communities to lead their own development (Easterly, 2007).
A case study from the Handbook on Humanitarianism and Inequality illustrates how a local NGO successfully implemented a community health program, achieving superior health outcomes with only 30% of the usual administrative budget (Roth et al., 2024). This shows the potential benefits of empowering local actors and decreasing reliance on costly international consultants. Participatory approaches, which emphasize the active engagement of local communities, are seen as more effective.
Case Studies and Reports
Although the breakdown of development funds can vary by project, donor, and implementing organization, many reports and studies highlight how much aid is absorbed by international organizations. For example, the Global Humanitarian Assistance Report (2022) regularly analyzes aid spending, pointing out how large portions are dedicated to operational costs rather than direct assistance.
Conclusion
The current structure of development aid raises crucial questions about efficiency, accountability, and the empowerment of local communities. Moving forward, it’s essential to rethink how resources are allocated to maximize aid impact and minimize dependency on international intermediaries. Prioritizing local expertise and adopting more equitable approaches, could lead to more effective, just and sustainable development outcomes.
In this blog, I have aimed to illuminate important discussions within development studies, particularly focusing on the decolonization of the development movement. By critically examining power dynamics and the colonial legacies that persist in global aid, I stress the importance of prioritizing local knowledge, expertise, and agency rather than relying on top-down, externally driven interventions.
I advocate for a transformation in how resources are allocated, challenging the predominance of international organizations that often perpetuate neocolonial power dynamics through their control over funding and decision-making processes. My goal is to decolonize development by empowering local communities to take an active role in shaping their futures, redistributing resources more equitably, and dismantling narratives that marginalize local voices in favor of international actors.
Bibliograghy
- Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
- Development Initiatives. (2022). Global Humanitarian Assistance Report 2022.
- Easterly, W. (2007) The white man’s burden: Why the west’s efforts to aid the rest have done so much ill and so little good. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, S. (1980). Encoding/Decoding in Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies. London , Hutchinson.
- Melber, H; Kothari, U; Camfield, L; & Kees B.(eds.) (2024). Challenging Global Development: Towards Decoloniality and Justice. Zed Books.
- OECD. (2021). Development Co-operation Report 2021.
- Roth, S; Purkayastha, B; Denskus, T. (eds.) (2024). Handbook on Humanitarianism and Inequality. Routledge.
من التبعية إلى الاستقلال: إنهاء استعمار تدفق أموال المانحين
بقلم: ف إ
المقدمة
قبل عدة سنوات، عملت في مشروع لمنظمة دولية تتلقى تمويلاً كبيراً. لفت انتباهي مدى قلة هذا التمويل الذي يصل بالفعل إلى المجموعة المستهدفة. بدا أن التركيز الأساسي كان على إعادة تخصيص الأموال داخليًا لمعالجة التقليصات في المؤسسة، ومن ثم تعديل البرنامج للمستفيدين المستهدفين لاحقًا.
هذه المدونة تستعرض تخصيص الأموال في برامج التنمية، مسلطةً الضوء على الفجوة بين ما تمتصه المنظمات الدولية من تمويل وما يصل إلى البلدان أو المجتمعات المستهدفة.
مثال على توزيع التمويل
لنأخذ على سبيل المثال مشروع تنموي بميزانية إجمالية قدرها 10 ملايين يورو، تموله جهات مانحة دولية. فيما يلي توزيع نموذجي يعكس أنماط الإنفاق المعتادة:
– التكاليف الإدارية والتشغيلية (45% – 4.5 مليون يورو): تغطي هذه الفئة الرواتب للموظفين الدوليين، وتشغيل المكاتب (إيجار، تقنية، لوازم)، والسفر، والنفقات العامة لإدارة البرنامج.
– الرصد والتقييم وإعداد التقارير (20% – 2 مليون يورو): يُخصص هذا الجزء لجمع البيانات، وإعداد تقارير النتائج، والتدقيق في مساءلة الجهات المانحة، وورش بناء القدرات للموظفين الدوليين.
– التنفيذ المحلي وبناء القدرات (10% – 1 مليون يورو): يدعم تدريب الموظفين المحليين، وورش العمل، والمواد اللازمة لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي وخبراته.
– التنفيذ المحلي للبرنامج (15% – 1.5 مليون يورو): تُموَّل التكاليف المباشرة للمشروع مثل البنية التحتية، رواتب الموظفين المحليين، الخدمات، وشراء الموارد المحلية من خلال هذا التخصيص.
– التواصل المجتمعي والتوعية (5% – 500 ألف يورو): الحملات التوعوية العامة، المبادرات التعليمية، والتواصل الإعلامي الذي يستهدف إشراك المجتمعات المحلية يغطيها هذا التخصيص.
– والمساعدة المالية المباشرة (5% – 500 ألف يورو): تُقدَّم المنح أو المساعدات المالية إلى المستفيدين مثل الشركات، المدارس، والمراكز الصحية.
يعكس هذا التوزيع النموذجي أنماط الإنفاق المعتادة في المشاريع التنموية الدولية الممولة من جهات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أو البنك الدولي.
المساءلة والكفاءة
أحد المخاوف الكبرى في هذا النوع من تخصيص الميزانيات هو مدى امتصاص التمويل من قبل المنظمات الدولية بدلاً من أن يستفيد منه المجتمعات المحلية بشكل مباشر. يتم استهلاك ما يقرب من 80% من المساعدات التنموية في التكاليف الإدارية والتشغيلية، مما يترك ما يقارب 20% فقط للتنفيذ المحلي المباشر والمساعدات. وقد تعرضت هذه النسب لانتقادات واسعة بسبب عدم كفاءتها. يشير باحثون مثل ويليام هيستيري إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة للتنمية يعاد توجيهه لدعم البيروقراطيات بدلاً من الوصول إلى المستفيدين المقصودين (إيستيرلي، 2007).
على سبيل المثال، كشف تقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2021 أن في بعض السياقات الإنسانية، تصل نسبة 70% من الأموال إلى التكاليف الإدارية، مما يحد من المساعدات المباشرة للسكان المتضررين. وتكرر هذه الانتقادات في عمل ميلبر وآخرين (2024) الذين يؤكدون الحاجة إلى توزيع أكثر إنصافًا للموارد بما يتماشى مع احتياجات السياقات المحلية.
بينما يدافع المانحون عن التكاليف الإدارية باعتبارها ضرورية للمساءلة والإشراف، يرى النقاد أن هذه النفقات غالبًا ما تحول الموارد الضرورية عن المجتمعات المحلية. يشير تقرير المساعدات الإنسانية العالمية (2022) إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويل يُخصص للرصد والتقييم بدلاً من المساعدات المباشرة على الخطوط الأمامية، مما يقوض الأثر العام للمشاريع التنموية. يوضح مفهوم “مجتمع الشبكة”، الذي صاغه مانويل كاستيلز، كيف تستغل المنظمات الدولية الشبكات المالية والمعلوماتية العالمية لتبرير ارتفاع تكاليفها العامة (كاستيلز، 1996).
ديناميات القوة في المساعدات
يعكس هذا الخلل في توزيع التمويل ديناميات قوى عالمية أعمق. غالبًا ما تعمل المنظمات الدولية كحراس بوابات، تتحكم في الموارد مع تعزيز التبعية والعلاقات غير المتكافئة بين المانحين والمتلقين. يدعم هذا النقد روث وآخرون (2024)، حيث يشيرون إلى أن المنظمات المحلية غالبًا ما تتعرض للتهميش لصالح الكيانات الدولية، مما يؤثر على مدى ملاءمة المشاريع ويعيق تطوير القدرات المحلية.
الطريقة التي تؤطر بها المنظمات الدولية سرديات التنمية غالبًا ما ترفع من دورها باعتبارها “خبراء”، بينما تقلل من أصوات المجتمعات المحلية. تساعدنا نظريات الاتصال، مثل نموذج التشفير/فك التشفير لستيوارت هول، في فهم كيف تشكل هذه المنظمات الخطاب التنموي، حيث تقدم نفسها على أنها لا غنى عنها مع تقييد المشاركة المحلية (هول، 1980).
الخبرة المحلية مقابل الدولية
مسألة رئيسية في نقاش المساعدات هي التوازن بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية. هل ينبغي تخصيص المزيد من التمويل للمنظمات المحلية لتمكينها، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء الدوليين المكلفين؟ ينتقد إيستيرلي الاعتماد الكبير على الاستشاريين الدوليين، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يغفل عن إمكانيات المجتمعات المحلية في قيادة تنميتها الخاصة (إيستيرلي، 2007).
توضح دراسة حالة من “دليل العمل الإنساني وعدم المساواة” كيف نفذت منظمة غير حكومية محلية برنامجًا صحيًا مجتمعيًا بنجاح، محققة نتائج صحية أفضل باستخدام 30% فقط من الميزانية الإدارية المعتادة (روث وآخرون، 2024). يظهر هذا الفوائد المحتملة لتمكين الفاعلين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستشاريين الدوليين المكلفين. تعتبر الأساليب التشاركية، التي تؤكد على المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية، أكثر فعالية.
دراسات الحالة والتقارير
على الرغم من أن توزيع الأموال التنموية يمكن أن يختلف حسب المشروع أو الجهة المانحة أو المنظمة المنفذة، فإن العديد من التقارير والدراسات تسلط الضوء على مدى امتصاص المساعدات من قبل المنظمات الدولية. على سبيل المثال، يحلل تقرير المساعدات الإنسانية العالمية (2022) بانتظام الإنفاق على المساعدات، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا يُخصص للتكاليف التشغيلية بدلاً من المساعدة المباشرة.
الخاتمة
هيكل المساعدات التنموية الحالي يثير تساؤلات جوهرية حول الكفاءة والمساءلة وتمكين المجتمعات المحلية. في المستقبل، من الضروري إعادة التفكير في كيفية تخصيص الموارد لتعظيم تأثير المساعدات وتقليل الاعتماد على الوسطاء الدوليين. إن إعطاء الأولوية للخبرات المحلية واعتماد نهج أكثر إنصافًا قد يؤدي إلى نتائج تنموية أكثر فعالية وعدلاً واستدامة.
في هذه المدونة، هدفت إلى تسليط الضوء على المناقشات المهمة في دراسات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على إزالة الاستعمار من حركة التنمية. من خلال الفحص النقدي لديناميكيات القوة والإرث الاستعماري الذي لا يزال قائماً في المساعدات العالمية، أؤكد على أهمية إعطاء الأولوية للمعرفة والخبرة والوكالة المحلية بدلاً من الاعتماد على التدخلات من أعلى إلى أسفل والتي يقودها الخارج.
وأدعو إلى التحول في كيفية تخصيص الموارد، وتحدي هيمنة المنظمات الدولية التي غالبًا ما تديم ديناميكيات القوة الاستعمارية الجديدة من خلال سيطرتها على عمليات التمويل وصنع القرار. هدفي هو إزالة الاستعمار من التنمية من خلال تمكين المجتمعات المحلية من القيام بدور نشط في تشكيل مستقبلها، وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، وتفكيك الروايات التي تهمش الأصوات المحلية لصالح الجهات الفاعلة الدولية.